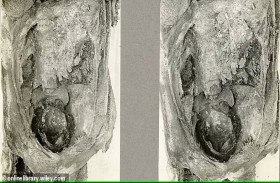من الدفيئات الكينية إلى الأسواق الأوروبية :
العولمة و السياسة حاضرة في ورود عيد فالنتاين !
الوردة الحمراء يمكن أن ترمز إلى أشياء كثيرة. في عيد الحب تصبح، بالنسبة للكثيرين، علامة الحب ودليلا على الحنان. إنها زهرة العشاق بامتياز. وفي روسيا، يتم تقديمها أيضًا في 8 مارس للأمهات كعربون تقدير لعملهن المنزلي. ولكن بالنسبة للجغرافيين، فإن الوردة الحمراء هي أيضًا رمزالعولمة. لأن الوردة التي ستقدمها أو تستقبلها في 14 فبراير من المرجح أن تأتي من الدفيئات الزراعية الموجودة في المناطق الاستوائية أو حتى على خط الاستواء، وبشكل أكثر دقة في كينيا أو إثيوبيا أو ربما في الإكوادور.
في البيوت الزجاجية، عمل مديرو الزراعة بجد لمدة 6 أشهر حتى تُزهر شُجيرات الورد الخاصة بهم “6 لكل متر مربع أو حوالي 60.000 لكل هكتار” على وجه التحديد في الأسبوع الذي يسبق 14 فبراير، ليس مبكرًا جدًا ولا متأخرًا جدًا بشكل خاص ، كل هذا اعتمادا على قدرات البيوت الزجاجية على تعديل مستويات الضوء والري وإمدادات ثاني أكسيد الكربون أو الأكسجين ومستويات الرطوبة من أجل تسريع أو إبطاء ازدهار شجيرات الورد.
عندما نعلم أن المسافة بين زهرتين تختلف باختلاف الضوء والغيوم ودرجة الحرارة ورطوبة الهواء وإمدادات المياه والأسمدة وما إلى ذلك، ونضيف إلى ذلك الهجمات المحتملة دائمًا للحشرات أو الفطريات، والتي تكون كارثية في سياقات الزراعة الأحادية هذه، فإننا نقوم بقياس حالة عدم اليقين والضغط الذي يسود المزارع مع اقتراب اليوم المنتظر .
من مناطق الإنتاج الاستوائية هذه، وبعد رحلة تستغرق بضع ساعات في عنابر طائرة شحن باردة، على سبيل المثال طائرة Boeing 747-Cargo التي يمكنها نقل ما يصل إلى 120 طنًا من الورود، ستنتقل الورود عبر شركة “رويال فلورا “ التعاونية الهولندية في آلسمير، على مرمى حجر من مطار أمستردام شيبول. وهناك، في نفس اليوم، سيتم تحميلها في إحدى شاحنات التبريد التي تجوب أوروبا وسيتم تسليمها إلى بائع الزهور الخاص الذي، تحسبًا لـ 14 فبراير، كان قد قام، قبل عيد الحب، بضرب طلباته بأربعة أو خمسة وأسعاره بـاثنين أو ثلاثة فقط بسبب الزيادة المفاجئة في الطلب. يوم العشاق هو أيضًا اليوم الذي يحقق فيه بائع الزهور ما يقرب من 15% من مبيعاته السنوية.
العوامل السياسية للإنتاج الكيني
إن سفر الورود آلاف الكيلومترات ليس ظاهرة جديدة. وبينما كانت أوروبا حتى ذلك الحين مكتفية ذاتيًا في الورود المقطوفة، بدأ الهولنديون في نهاية السبعينيات، مقلدين زملائهم الأمريكيين الذين بدأوا قبل بضع سنوات في إنشاء مزارع في الإكوادور، حول كيتو، وفي إنشاء وحدات إنتاج معينة في كينيا. ولكن لماذا وصلنا إلى عولمة إنتاج الورود المقطوفة بهذه الطريقة؟ في الواقع حفزت هذه الحركة نحو أفريقيا. أولاً، كان الأمر يتعلق بمغادرة أوروبا وتكاليف العمالة والتدفئة وأنظمة الصحة النباتية الناشئة. ثم بدت المرتفعات الكينية جذابة بشكل خاص بسبب عدد معين من المزايا المناخية: أولا، يوفر النظام البيئي الاستوائي المرتفع “بين 1600 و2300 متر اعتمادا على أحواض الإنتاج الكينية”، درجات حرارة “بين 12 درجة مئوية” دون تدفئة ليلاً و30 درجة مئوية نهارًا”، على مدار السنة، وهو مثالي لشجيرة الورد ونموها وإنتاجيتها. بعد ذلك، تضمن هذه المناطق لمعانًا يمنح الزهور ألوانها المبهرة، والساق القوة اللازمة للسفر، بالإضافة إلى الحجم المثالي لغزو الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام البيئي الجغرافي الاقتصادي لكينيا ما بعد الاستعمار مكّن من تعزيز هذا الموقع الاستوائي. كانت كينيا، مستعمرة بريطانية سابقة، تضم من ناحية جاليات من البيض والهنود على دراية بالإشراف على العمل في أفريقيا وقيود الرأسمالية الدولية، ومن ناحية أخرى قوة عمل سوداء كبيرة، ورخيصة، ومتعلمة، وغير متطلبة. فضلاً عن ذلك فإن كينيا، المحرك الاقتصادي لشرق أفريقيا، تتمتع بالفعل بمرافق لوجستية، وأبرزها مطار نيروبي، الذي يتناسب تماماً مع التدفقات السياحية، الأمر الذي يضع أوروبا على بعد ثماني ساعات بالطائرة. وأخيرا، قدم النظام الكيني الليبرالي والعملي والمستقر للمستثمرين الأمن والحرية.
لقد كان رواد الأعمال هؤلاء قدوة، وخلال التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تم تقليدهم من قبل المستثمرين الكينيين من أصل هندي والبيض وكذلك السياسيين الكينيين. ومن ثم توسعت المساحات المخصصة لزراعة الورود ، وتدريجيًا، تشكلت مجموعة حقيقية لزراعة الورد في كينيا، حيث اجتذب الإنتاج هناك مجموعة من الشركات المستحثة، في المنبع والمصب. واليوم، إذا كانت البيوت الزجاجية توظف بشكل مباشر 100 ألف شخص، فإن 500 ألف موظف يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر حول الزهرة.و في المجمل، يعتمد مليوني شخص على الورد في معيشتهم.
ومن وجهة نظر الاقتصاد الكلي، تساهم صادرات الورد بشكل حاسم في الميزان التجاري للبلاد “700 مليون دولار، في المرتبة الثانية بعد الشاي بقيمة 1400 مليون دولار”. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بعد أن اكتسحت الورود المرتفعات الكينية، تم إدخال الوردة الحمراء أيضًا إلى إثيوبيا، وهي دولة مجاورة لها خصائص مماثلة. وقد تم خلق 50 ألف فرصة عمل هناك من قبل مزارعي الورد، الذين كانوا يأتون في بعض الأحيان من كينيا بتحريض من السلطات الإثيوبية الأكثر تدخلاً. ومع ذلك، فإن سلسلة القيمة لم تصل إلى نفس مستوى النضج ويرتبط بها عدد أقل بكثير من الوظائف المستحثة، وبالتالي يظل حوض الإنتاج الإثيوبي في مدار جارتها الجنوبية. وإذا ركزنا الصورة الآن، فإننا نلاحظ طفرة في الورد الأفريقي رافقت نمو الاستهلاك العالمي وقتلت الإنتاج الأوروبي.
فلورا هولاند: وول ستريت للزهور
وجهة الورود عندما تغادر الدفيئات الإفريقية هي الاسواق الاوروبية و الأمريكية و لكن خاصة شركة “فلورا هولاند” الهولاندية ولذلك يتم تعبئتها في حزم، وتسويقها بثلاث طرق.إما في إطار أسواق الساعة “نظام مزاد إلكتروني يهدف إلى ضمان تحديد الأسعار بسرعة وشفافية” و إما في إطار عقد، غالبًا ما يكون سنويًا، بين المنتج ومركز شراء أو تاجر جملة أوروبي أو، أخيرًا، بمناسبة بيع خاص لمرة واحدة بين المنتج والمشتري.
وبغض النظر عن كيفية بيعها، سواء من نيروبي أو أديس أبابا، فإن غالبية الورود تمر عبر آلسمير - في ضواحي أمستردام - حيث توجد أكبر منصة لوجستية للنباتات في العالم: شركة فلورا هولاند التعاونية المربحة للغاية. تاريخياً، رسخت مكانتها باعتبارها وول ستريت للزهور، حيث يتم تثبيت أسعار الورود. وفي السنوات الأخيرة، وبدعم من النمو الذي لا يمكن إنكاره في الطلب من الطبقات الوسطى في البلدان الناشئة والزيادة في أسعار عوامل الإنتاج، ارتفع سعر الورود أكثر من التضخم. واليوم، حتى لو انخفضت حصة الزهور المباعة بالمزاد العلني “يتم بيع 40% فقط من الورود المقطوفة في المزاد”، فإن أسواق الساعات تحتفظ بهذا الدور الأساسي المتمثل في تحديد أسعار المنتج. ومن الممكن تفسير هذا الانخفاض النسبي في المزادات بارتفاع قوة المشغلين الأوروبيين ــ وخاصة سلاسل المتاجر الكبرى البريطانية والألمانية ــ الراغبة والقادرة على التفاوض بشأن كميات شراء كبيرة ومنتظمة مع المنتجين على مدار العام. هذه الكميات العادية الكبيرة هي موضوع العقود التي تحدد الكميات والأسعار على أساس سنوي، وتحرر البائعين والمشترين من المزادات.
لكن شركة “فلورا هولاند “ ، من خلال سيولتها، وأدائها اللوجستي، وضغوطها النشطة، واستراتيجياتها الترويجية، تظل، على الرغم من هذه التغييرات، المركز المهيمن الذي تمر عبره غالبية الورود المقطوفة المتجهة إلى الأسواق الأوروبية. تكافئ التعاونية أعضاءها وتدفع لموظفيها بفضل العمولات التي تتلقاها على الكميات المباعة في المزاد وعلى تلك التي كانت موضوع مبيعات تعاقدية أو خاصة ولكنها مرت عبر جدرانها.
عولمة الوردة موضع تساؤل على نحو متزايد
إلا أن هذه الورود التي تعبر العالم لا تخلو من الانتقادات بما في ذلك وسائل الإعلام، منذ بداية سنة 2000 ترددت عدة اسئلة بانتظام.
في الأعوام 2000-2005، ركزت الأسئلة أولاً على ظروف العمل وأجور الموظفين، ثم في الأعوام 2005-2010، على الاستهلاك المفرط للمياه اللازمة لشجيرات الورد “بين 3 و9 لترات من الماء يومياً لكل متر مربع” وتلوث المياه الناجم عن التصريفات الناتجة عن هذا الإنتاج.
وفي الأعوام 2010-2015 كان ذلك الحين آثار الكربون للزهور الناتجة عن الاستخدام الضروري للطائرة التي تم فحصها. وفي الآونة الأخيرة، أخيرًا، في الأعوام 2015-2020، كان الحمل الكيميائي لهذه الزهور واستراتيجيات التهرب الضريبي لرواد الأعمال الذين يحددون أرباحهم في هولندا حيث يبلغ معدل الضريبة 12.5% مقارنة بـ 35% في كينيا، والتي أصبحت من القضايا الناشئة.
وإدراكاً منهم للمخاطر التي يفرضها عليهم هذا التهديد الإعلامي، استجاب أصحاب المشاريع إلى حد ما للانتقادات من خلال زيادة الأجور وتوفير ظروف عمل أفضل للعمال، ومن خلال الحد من بصمتهم المائية من خلال إعادة التدوير وحصاد الأمطار، ومن خلال الحد من المبيدات الحشرية و الرش بفضل العلاجات المستهدفة والمكافحة البيولوجية المتكاملة.
هناك ظاهرة أخرى غير مسبوقة، كرد فعل على هذا الإنتاج المعولم للزهور ولانتقادات التكاليف البيئية للإنتاج الاستوائي، حيث تظهر، ببطء شديد، فكرة “إعادة موسمية” استهلاك الزهور المقطوفة وإعادة توطين إنتاج الزهور في فرنسا وفي البلدان الأنجلوسكسونية، و تؤيد حركة الزهور البطيئة هذه الفكرة، ونحن نشهد ببطء ازدهار المزارع الصغيرة حول المدن الكبرى، غالبًا في عملية إعادة تحويل، أو بدوام جزئي. في فرنسا عام 2017، قام بائع زهور من الشمال وصحفي بإنشاء جمعية تضم حوالي 600 عضو من بائعي الزهور أو مزارعي الزهور المسؤولين عن البيئة - هدفها هو تعزيز إنتاج وتسويق الزهور المنتجة في فرنسا وبالتالي المشاركة في الزراعة المسؤولة بيئيًا.
الوردة الحمراء: شوكة في خاصرة مجتمعاتنا المعولمة؟
وهكذا أصبحت الوردة الحمراء شيئاً غامضاً على نحو متزايد: فرغم أنها أصبحت موضوعاً لمزيد من الانتقادات، فإن إنتاجها مستمر في التوسع، بدعم من الطلب المتزايد من جانب الطبقات المتوسطة في البلدان الناشئة. لقد تحدث المحترفون عن نمو يبلغ حوالي 5/6% سنويًا لمدة عشر سنوات تقريبًا.
حتى أن الصناعة تمكنت من الصمود في وجه جائحة كوفيد - 19 العالمي بشكل جيد نسبيًا. بعد الأسابيع الأولى من الحجر الصحي الذي أدى إلى توقف الرحلات الجوية والمشتريات تمامًا، مما أجبر البستانيين على التخلص من إنتاجهم، تم التفاوض بشكل جيد نسبيًا على جائحة كوفيد من قبل القطاع لسبب بسيط وهو أن الناس استمروا في شراء الزهور، عبر الإنترنت بشكل واضح، و حتى مع المزيد من الانتظام، وهي العادة التي استمرت منذ ذلك الحين! في الواقع، زاد الاستهلاك الجمالي خلال الوباء، مما أثار دهشة وسرور العاملين في هذا القطاع.
مثل أي كائن معولم، فإن الوردة تبلور التوترات بين، من ناحية، عدم الاستدامة البيئية الواضحة للمحصول في غير موسمه، وإنتاجه وخاصة عمليات التسويق، ومن ناحية أخرى، الواقع الاقتصادي: فالورد يدعم عدة ملايين من الأشخاص وتساهم - بما يتجاوز إثراء القلة - في تنمية العديد من المناطق. وبالتالي فإن هذه الزهرة تدعونا إلى أن نسأل أنفسنا أسئلة حساسة: إلى أي مدى يبرر التطور الذي لا يمكن إنكاره والذي تحقق في كينيا الحفاظ على استهلاكنا غير المستدام في أوقات تغير المناخ هذه؟ فهل ينبغي لنا أن نستسلم لابتزاز العمالة الذي يمارسه هذا القطاع الذي يعيش على استهلاك يتسم بالتباهي بقدر ما هو غير ضروري؟
وبعيدًا عن الورود، يمكن، أو حتى ينبغي، فحص جميع الاستهلاكات الاستوائية بهذه الطريقة. لأنه إذا كان المعنى الرمزي القوي الناتج عن شراء وردة قد يفضي إلى طرح أسئلة حول طريقة إنتاجها، فإن الأسئلة البيئية والاقتصادية يمكن أن تمتد إلى العديد من المنتجات الأخرى: القهوة والشوكولاتة والشاي والأفوكادو والمانجو والموز...
على الجانب الكيني، لا توجد تحديات
في كينيا، حتى الآن، وبعيدًا عن الجدل الإعلامي حول أساليب الإنتاج، لا يبدو أن أي تحول نموذجي متصور أو ممكن: فالصناعة لا تواجه مشكلة التوظيف ويقول عمالها إنهم سعداء بالاستفادة من المكاسب غير المتوقعة التي تنمو في الورد والتي تضمن راتبًا ثابتًا أعلى من متوسط الدخل، وإمكانية فتح حساب مصرفي حتى لو لم يكن لديهم شك في عدم تناسق الأرباح وعدم المساواة في تقاسم القيمة.
إن الاحترام العميق لشخصية رجل الأعمال، والالتزام العالمي بروح الرأسمالية، وبشكل أكثر واقعية المزايا المادية والرمزية التي يمكن اكتسابها من أعمال مزدهرة ومعترف بها، كل هذا يساهم في جعل زراعة الورود قطاعًا صغيرًا جدًا يواجه التحديات. وحقيقة أن الشركات التي افتتحت في التسعينيات اضطرت إلى إدارة المشاكل الصحية التي يواجهها موظفوها البالغون من العمر خمسين عاماً تظهر أيضاً انخفاض معدل دوران القوى العاملة المحسودة و المتعلقة بوظيفتها. علاوة على ذلك، في بلد يتم فيه تقدير شخصية السياسي، فإن حقيقة أن بعض الشركات مملوكة لسياسيين من النساء/الرجال تساهم بلا شك في هالة الدفيئات الزراعية والزهور. وعلى الجانب الأوروبي، وإدراكاً لتساؤلات المستهلكين، بدأ تجار الجملة وتجار التجزئة في الاستجابة بشفافية وإمكانية التتبع. و هو نهج مثير للاهتمام يتكون من الإشارة إلى الأصل الجغرافي لكل من الأصناف المباعة ويكشف بوضوح عن القيمة السياسية للاستهلاك. ما المعنى الذي يعطيه المستهلك لشرائه؟ بيئية أم تنموية؟ محلية أم استوائية؟ ولا شك أن إعادة استثمار المعنى في قلب الاستهلاك تساهم في تجزئة السوق.
في النهاية، إذا كانت الوردة علامة متفق عليها للحب، وموضوعًا رائعًا لدراسة العولمة بالنسبة للجغرافيين، فإنها تعمل على تكثيف التوترات والتناقضات في الرأسمالية الحالية. .